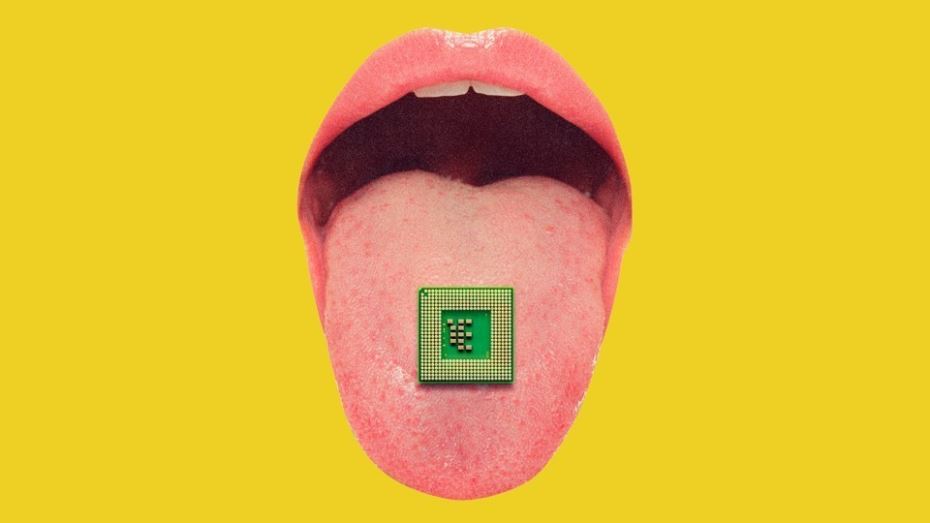ترجمة بواسطة – شهاب ممدوح
في زاوية غير أخلاقية من الإنترنت, يمكن العثور على ممثلات من مسلسل "لعبة العروش" أو فيلم "هاري بوتر" وهن يمارسن أفعالاً جنسية مختلفة. بالنسبة للمشاهد, على الأقل, فإن النساء المثيرات في الفيديو يشبهن هؤلاء الممثلات, ووجوههن هي بالفعل وجوه هؤلاء الممثلات. لكن الحقيقة هي أن أجساد هؤلاء النساء في الفيديو ليست أجساد الممثلات ولكنها أجساد نساء أخريات. إذ تمكّن الذكاء الاصطناعي بسلاسة تقريبا من لصق وجوه هؤلاء الممثلات المعروفات في مشاهد إباحية. إن هذا الفعل هو أحد أبشع أشكال سرقة الهوية وأكثرها اختراقا للخصوصية في عصر الإنترنت. إن جوهر هذه البشاعة يتمثل في فعّالية التكنولوجيا المستخدمة: المراقب العادي لن يستطيع اكتشاف الخديعة بسهولة.
يعود هذا التطور التكنولوجي, والذي أثار القلق في أوساط الصحافة المهتمة بالتكنولوجيا, إلى برنامج يطلق عليه اسم "ديب فايكس" (deepfakes). وهو مجرد نسخة تجريبية لمشروع أكثر طموحًا. قال أحد المبرمجين -في برنامح "ديب فايك" لموقع "مزر بورد" التابع لمجموعة "فايس" (Vice) الإعلامية في شهر يناير- إنه يرغب في دمقرطة هذا العمل. هو يرغب في تحسين العملية, وإدخال مزيد من الأتمتة إليها, ما سيسمح لأي شخص بلصق رأس محبوبه أو شريكه السابق أو زميله في العمل في فيديو إباحي عبر خطوات بسيطة. إذ لن تكون هناك حاجة إلى معرفة تقنية.
وبفضل تطوير المختبرات الأكاديمية والتجارية لأدوات أكثر تطورًا لاستخدامها في أغراض غير إباحية -خوارزميات تستطيع التعرف على تعابير الوجه, وتقليد الأصوات بدقة- فإن تلك الأعمال المزيّفة ستكتسب قريبا قدرًا أكبر من الصدقية.
لطالما كان الإنترنت يحمل في طياته بذور جحيم عالم ما بعد الحداثة. إذ بات التلاعب الواسع النطاق -بداية من روابط اصطياد النقرات, ومرورا بالحسابات الآلية الروسية, وصولا إلى الخداع الذي يسيطر على خلاصة الأخبار في موقع الفيسبوك- أمرًا شائعًا. لطالما كان الإنترنت مكانًا يصعب جدا فيه التعرف على الهوية, ويؤدي عدم الكشف عن الهوية فيه إلى نشر البذاءة والبلبلة. وفي هذا الصدد, فإن بروز ظاهرة الفيديوهات الإباحية المزيفة (the Deepfakes) هو تتويج لما وصل إليه الإنترنت حتى تاريخنا هذا، وربما يكون هذا مجرد نسخة بسيطة لما هو آت.
قال الكاتب "فلاديمير نابكوف" مرة: إن الحقيقة هي واحدة من الكلمات القليلة التي لا تعني شيئا من دون علامات اقتباس. لقد كان ذلك الكاتب يشير بطريقة تهكّمية إلى نقطة أساسية تتعلق بالتصورات النسبية: عندما ننظر أنا وأنت إلى الشيء ذاته, فكيف نعلم اننا نرى الشيء ذاته؟ مع ذلك, ساعدت مؤسسات (مثل وسائل الإعلام والحكومة والأوساط الأكاديمية) في جعل الناس تلتف حول توافق للآراء بشأن كيفية وصف العالم, وإن كان هذا التوافق هش وفي حالة تراجع خلال السنوات الأخيرة. لقد ساعدت وسائل التواصل الاجتماعي في بزوغ عصر جديد, إذ باتت الأخبار مصممة لتناسب أهتمامات الأفراد وتحيّزاتهم. لقد عجّل الرئيس الحالي من مجيء عالم يتجاوز الحقيقة, وجعل المنصب الأعلى في الدولة عرضة للأكاذيب والمؤامرة.
نحن نتشبث بالحقيقة اليوم, بل أننا حتى نتشوق إليها. نحن مازلنا نعيش في عالم "أبراهام زابرودر" (صانع الملابس الذي صوّّر لحظة اغتيال كيندي). أي أنا نبجّل الصور الخام المتمثلة في الفيلم المنزلي لاغتيال الرئيس "جون كيندي"والذي صوّره "زابرودر" في "دالاس" بالصدفة.
لقد اكتسبت الفيديوهات غير المنقّحة سلطة هائلة في ثقافتنا. وذلك سببه أن الجمهور صار لديه تشكك كبير وغير عقلاني تجاه التقارير الإخبارية والمواد الأخرى التي تناولتها وعالجتها وسائل الإعلام- وهو رد فعل مفرط على قرن من الإعلانات والبروباغندا والأخبار التلفزيونية التهويلية.
إن السلوكيات الشائنة تثير غضبا جماهيريا واسعا عندما "يتم التقطاها على شريط فيديو". لعبت مثل تلك الفيديوهات دورا حاسما في تشكيل أخر عمليتين انتخابيتين رئاسيتين. فخلال حفل لجمع الأموال للمرشح الرئاسي "ميت رومني" في ولاية فلوريدا, في عام 2012, شغّل نادل كاميرته خلسة بينما كان ذلك المرشح يهاجم "47 بالمائة" من الأمريكيين -كل مؤيدي أوباما- ويصفهم بأنهم أشخاص ضعفاء يعتاشون على معونات الحكومة. هناك احتمال قوي بأن مقطع الفيديو الذي سُجل خلسة دمّر فرصة رومني في أن يصبح رئيسا. إن تلك التصريحات ما كانت لتؤثر بهذا الشكل لو كان أحد المراسلين اكتفى بتدوينها أو كتابتها على ورقة. لقد كان الفيديو -الذي التُقط بزاوية غير مباشرة, وسط ضجيج أدوات المائدة, والنوادل الذين يمرون, حاملين معهم المناديل المطوية- مؤثرا وفعالا للغاية.
من غير المحتمل أن يكون دونالد ترمب قد نجح في تجاوز فضيحة الشريط المسجّل الذي نشره موقع "أكسيس هوليود", والذي تفاخر فيه باعتدائه جنسيًا على النساء, ولقد أيقظ هذا الشريط المسجل عواطف وضمائر الجمهور بشكل لا مثيل له في الانتخابات الرئاسية عام 2016. وبالمثل, سلّطت لقطات الفيديو الضوء مؤخرا على حوادث اجتماعية عديدة أخرى. إذ أظهرت لقطات كاميرات المراقبة أحد اللاعبين في اتحاد كرة القدم الامريكية "راي رايس" وهو يجرّ زوجته الفاقدة للوعي من مصعد في أحد الفنادق, وقد دفعت تلك اللقطات اتحاد الكورة لاتخاذ موقف جدّي ضد مسألة العنف ضد المرأة, بالرغم من تاريخ اللاعبين الطويل في العنف الأسري. ثم بعد ذلك, وقعت حادثة قتل "فيلاندو كاستيل" عام 2016 على أيدي ضابط شرطة في "مانيسوتا", إذ قامت صديقته ببث تلك الحادثة مباشرة على الفيسبوك. إن كل التقارير الإخبارية في العالم, بالرغم مما تحتويه من إحصائيات مذهلة وقصص صادمة, فشلت في إثارة غضب الناس بشأن وحشية الشرطة. لكن البث المباشر المفزع لحادثة مقتله البشعة, أثارت الجمهور, ودفعت السياسيين, وحتى بعض المعلقين المحافظين, للاعتراف في النهاية بوجود هذا النوع من إساءة المعاملة, وهو أمر تجاهلوه طويلا.
الفيديوهات المزيّفة ستخلق شكوكًا جديدة بشان كل شيء نشاهده. والسياسيون سيستغلون تلك الشكوك.
كل هذا يقودنا إلى أساس المشكلة. من الطبيعي أن يثق المرء في حواسه, وأن يصدق ما يراه -هذا الاستعداد الطبيعي لدينا سيتم استغلاله في العصر المقبل للفيديوهات المزيفة. فلنلق نظرة على الأحداث المثيرة الأخيرة, وما يصفة "أفيف عوفاديا" من جامعة "ميتشجن" بأنه "نهاية زمن المعلومات" (Infopocalypse)- وتخيلوا كيف أن تلك الأحداث كان يمكن أن تكون أسوأ بكثير لو كانت مصحوبة بفيديوهات مزيّفة. خذوا مثلا فضيحة "بيتزا جيت", ثم أضيفوا إليها صورًا مزيّفة لــ"جون باديستا" وهو ينظر بشهوانية إلى أحد الأطفال, أو أسوأ من ذلك. إن تزييف الحقائق سيكتسب بُعدا عاطفيا قويا جديدا.
لكن المشكلة لا تكمن فقط في نشر الأكاذيب. فالفيديوهات المزيّفة ستخلق شكوكًا جديدة مفهومة بشأن كل شيء نشاهده. وسيستغل السياسيون ومسؤولو الدعاية هذه الشكوك. فعندما يتم التقاط صور لشخص وهو يقوم بعمل سيئ, سيعلن الجاني ببساطة أن الدليل المرئي كان مجرد تزييف خبيث. وقد أجاد الرئيس ترمب بالفعل, كما تقول التقارير, هذا الأسلوب: فبالرغم من اعترافه في البداية بمصداقية الفيديو الذي نشره موقع "هوليود أكسيس", إلا انه أبدى شكوكًا, في السر, حول ما إذا كان الصوت في الفيديو يعود إليه أم لا.
إن انهيار الحقيقة ليس نتيجة غير مقصودة للذكاء الاصطناعي. فلطالما كان ذلك هدفًا لبعض من أشهر مهندس التكنولوجيا. تبدأ قصة "وادي السليكون" في بداية عقد الستينيات في القرن الماضي من خلال "المؤسسة الدولية للدراسات المتقدمة" الواقعة بالقرب عن مختبرات الهندسة الشهيرة الكائنة حول "ستانفورد". تخصصت المؤسسة في إجراء تجارب على عقار الهلوسة "إل إس دي" (LSD). لم يستطع بعض التقنيين الذين يعملون في المكان مقاومة إغراء العقار, وتناولوا بعضا منه, وكل ذلك بالطبع كان باسم العلم. لقد أراد هؤلاء المطوّرون تصنيع آلات بمقدورها تحويل الوعي البشري بالطريقة ذاتها التي تقوم بها المخدرات. وكان الهدف أيضا أن تحدث الحواسيب ثقبا في الواقع, ما يجعل البشر يبتعدون عن نمط الحياة التقليدي والممل إلى حالة ذهنية أكثر إثارة وروعة. وقد وصف "ستيف جوبز" عقار "أل أس دي" بأنه "واحد من أهم اثنين أو ثلاث" تجارب في حياته.
إن مقاطع الفيديو المزيّفة -التي تتسم بالواقعية في الوقت ذاته- ليست هي نقطة النهاية فيما يخص مسألة الحقيقة والتزييف. فالواقع الافتراضي هو درة التاج في هذا المجال. فالهدف الأساسي للواقع الافتراضي هو خلق وهم شامل لدى الإنسان يجعله يظن أنه في مكان آخر. يهدف الواقع الافتراضي, عبر النظارات والقفازات, لخداع حواسنا, وتقويض تصوراتنا. لقد بدأت ألعاب الفيديو عملية نقل لاعبيها إلى عالم بديل, ووضعهم في رواية أخرى. لكن بينما تتسبب ألعاب الفيديو في إدمان لاعبيها, إلا أنها لا تجعلهم منفصلين تماما عن الواقع. لكن الواقع الافتراضي, على الجانب الآخر, لديه القدرة على فصل الأشخاص تماما عن الواقع- فنحن سنري ما تراه صورنا التجسيديه (الأفاتار) وسنشعر بما تشعر به. قبل عقود خلت, نُقل عن عالم النفس المؤيد لاستخدام عقاقير الهلوسة "تيموثي لييري" وصفه لتكنولوجيا الواقع الافتراضي, الوليدة حينها, بأنها "عقار LSD الجديد".
قد تكون الحياة أكثر إثارة مع زيادة انتشار تكنولوجيا الواقع الافتراضي. لكن في حال زادت الضجة حول تكنولوجيا الواقع الافتراضي في نهاية المطاف, فإنها ستتحول, مثلها مثل الحاسوب الشخصي ووسائل التواصل الاجتماعي, إلى صناعة ضخمة, عازمة على جعل المستهلكين يدمنون عليها لتحقيق إرباح, فضلا عن احتكار تلك التكنولوجيا من قِبل شركة أو شركتين قويتين للغاية (استثمارات شركة فيسبوك في الواقع الافتراضي, عبر شرائها شركة (Oculus) الناشئة لا يبعث مطلقا على الاطمئنان).
ستزداد قدرة الشركات على التلاعب بالمستهلكين, لأن الواقع الافتراضي يخلق حالة من الإرباك بشأن ما هو حقيقي. ذكر مصممو تكنولوجيا الواقع الافتراضي أن بعض المستهلكين أظهروا ردود فعل عاطفية قوية بعد تعرضهم لتجارب مخيفة, ما جعلهم ينزعون نظاراتهم الكبيرة والهروب. كما أظهرت الدراسات كيف يمكن استخدام الواقع الافتراضي للتأثير على سلوك المستخدمين بعد عودتهم للعالم الحقيقي, ما يجعلهم أكثر أو أقل ميلاً للسلوكيات الإيثارية.
ربما سيجد المجتمع طرقًا للتعامل مع تلك التغيرات. ربما سنتعلم الشك المطلوب لشقّ طريقنا عبرها. لكن, حتى الآن, أظهر البشر قابلية لا محدودة لأن يتم خداعهم والاحتيال عليهم- الانخداع بسهولة بعوالم تتطابق مع معتقداتهم وصورتهم الذاتية, بغض النظر عن مدى غرابة أو عدم صحة تلك المعتقدات. لقد كان الحكومات بطيئة في الرد على تلك التغيرات الاجتماعية التي خلقتها التكنولوجيات الحديثة, وربما أنها تفضل تفادي ذلك الأمر.
عدد قليل فقط من الأفراد سيكون لديهم الوقت او ربما المقدرة على فرز الخيال الواسع عن الحقيقة. إن أملنا الوحيد ربما يتمثل في الاستعانة بمصادر خارجية لحل تلك المشكلة, وإعادة السلطة الثقافية إلى جهات موثوق فيها مهمتها الثبُّت من الحقائق, ولديها التدريب والتكنولوجيا اللازمين: الصحف والجامعات. ربما ستفهم شركات التكنولوجيا الكبيرة تلك الأزمة وتتولى دورًا في حلها أيضا. وبفضل امتلاك تلك الشركات لأهم نقاط الوصول إلى الأخبار والمعلومات, فإنها بذلك تستطيع بسهولة القضاء على الفيدوهات المزيّفة, على سبيل المثال. ولكن, لكي تلعب تلك الشركات هذا الدور, سيتعيّن عليها القبول بمسؤوليات رفضت حتى الآن تحمّلها.
في عام 2016, ومع استخدام روسيا لموقع الفيسبوك للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية, عبّر الملياردير والمخترع "إيلون ماسك" عن فهمه للحياة البشرية. إذ تحدث عن نظرية يتبناها فيلسوف في جامعة "أوكسفورد" تفيد بأننا نحن البشر نعيش ضمن محاكاة حاسوبية, وأننا مجرد شخصيات في فيلم للخيال العلمي أو لعبة فيديو. إذ كان قادة صناعة التكنولوجيا, والذين يشرفون على معلوماتنا وأمالنا بتشكيل مستقبلنا, لا يمكنهم حتى الاعتراف بوجود الواقع, فإننا لدينا أمل ضعيف في إنقاذ هذا الواقع.
المصدر – ذى أتلانتيك
للإطلاع على الموضوع الأصلي .. اضغط هنا
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=7253